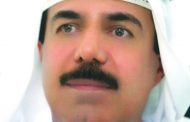بقلم: د. خالد التوزاني
كلما وقع حادث إرهابي، أو تعبير عن التطرف والكراهية، تتجدد الأسئلة حول الدوافع العميقة التي تدفع أفراداً أو جماعات إلى تبني أفكار متطرفة تنتهي بالعنف، وبينما تُعالج الظاهرة عادةً من منظور أمني، تبقى الجذور النفسية والاجتماعية عاملاً حاسماً لفهمها ومنعها، فما هي العوامل النفسية التي تجذب الأفراد إلى التطرف؟ وكيف تساهم السياقات الاجتماعية في تغذية هذه الظاهرة؟
من أهم العوامل النفسية التي تقف وراء الميل إلى التطرف، هو الهشاشة النفسية والإحساس بالاغتراب والاستلاب، فبعض الأفراد وخاصة في المناطق الهامشية البعيدة عن المدن الكبرى، قد يشعرون بالعزلة والوحدة، الشيء الذي يدفعهم إلى البحث عن هوية بديلة تمنحهم الإحساس بالانتماء، ولأن الغالبية من الشباب اليوم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي فإن الجماعات المتطرفة تنشط في هذه المواقع، وتؤسس مجتمعاً افتراضياً يقوم على شعارات الأخوة والتضامن والشعور المشترك بالوحدة والغربة عن الحياة الواقعية، وهذه الصفحات تستقطب هؤلاء الشباب، لأنهم يشعرون فيها بالثقة وفرصة إثبات الذات والتعبير عن رفض الواقع والرغبة في التمرد وتغيير الوضع، كما أن شعورهم بالانتماء إلى مجتمع متعدد الجنسيات لكنه يؤمن بقيم واحدة وبهدف مشترك عادة ما يكون عبارة عن أحلام بتحقيق الرخاء والعدالة وتقاسم ثروات الأرض وخيراتها أو الاستشهاد والحصول على الحور العين وجنات النعيم ودرجات المقربين مع الشهداء والأنبياء والصالحين، فتبدو هذه الأحلام منسجمة مع ما يحتاجه الشباب ويحلمون بتحقيقه، ما يدفعهم إلى تأكيد ولائهم لهذه الجماعات المتطرفة.
ولذلك، ينبغي الانتباه إلى السلوكات التي تسبق الانضمام إلى هذه الجماعات، وهي مظاهر تبدو في سلوك بعض الشباب، وينبغي ملاحظتها، وتتمثل في الميل إلى العزلة وتفضيل الجلوس وحيداً وخاصة مع استخدام الهاتف أو الحاسوب المرتبط بشبكة الانترنيت، حيث يبتعد عن أسرته وأصدقائه، وأحياناً ترافق هذا السلوك تغيير مفاجئ في عاداته اليومية، مثل ترك الدراسة أو العمل دون أسباب واضحة.
وأيضاً في حديثه قد نلحظ تمجيداً وإشادة ببعض الأفكار المتطرفة، وخاصة تبخيس الآخرين والتقليل منهم، والدعوة إلى محاربتهم والقضاء عليهم، وتتطور هذه المشاعر والأفكار إلى خطاب عدائي تجاه الدولة والمجتمع، وقد تصل إلى عداوة الوالدين والأقارب واتهامهم بالكفر والانحراف، وهنا تكون درجة الخطورة قد بلغت مستوى مرتفعاً، وتستوجب تدخلا من أهل الاختصاص من أجل حماية هؤلاء الشباب من هذه الأفكار الهدامة.
هناك من الباحثين من يربط بين الهشاشة الاجتماعية وخاصة التخلف المجالي أي نقص التنمية، وبين ارتفاع منسوب التطرف عند الشباب، وهذه الفرضية كانت شائعة قبل عقدين من الزمان، وخاصة بعد تفجيرات الدار البيضاء، لكن ثبت فيما بعد أن الإرهاب والتطرف لا علاقة له بالمجال، فهو يوجد في المناطق المتقدمة مثلما يوجد في الأماكن المتخلفة عن ركب التنمية، ولذلك فإن الأسباب النفسية هي العامل الأكثر تأثيراً.
العوامل الاجتماعية والثقافية التي تسهم في انتشار خطاب الكراهية
بداية ينبغي التأكيد على أن خطاب الكراهية يعدُّ استثناءً، وتياراً دخيلاً على المجتمعات الإنسانية المتماسكة والمتصالحة مع ذاتها، لأن أساس هذه المجتمعات يقوم على احتضان الآخر المختلف وقبوله، وفيخلق بيئة تشجع على التسامح والتواصل والانفتاح، ولذلك لم تعهد تلك المجتمعات خطاب الكراهية، فهو حالة مستجدة، وربما لها صلة بتحولات العصر، وتحديداً ما له صلة بتكنولوجيا التواصل والإعلام، وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يستغلها بعض مستخدمي هذه المواقع في الإساءة إلى الآخر وفي نشر الشائعات وفي التنمر ونشر الإحباط أو إثارة بعض المشكلات.. وغالبا ما يختار أصحاب هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الاختفاء وراء أسماء مستعارة وهوية غامضة، الشيء الذي يوحي بأنها شخصيات تملك المعرفة ولكن لا تريد أن تكون معروفة، ولعل ذلك راجع لرغبتها في زرع التفرقة وتشتيت وحدة المجتمع وزعزعة القيم والأخلاق الفاضلة وعلى رأسها التسامح وقبول الآخر.
وهكذا، إن ظاهرة التطرف والكراهية والعنف، وإن كانت أسبابها مرتبطة بالبعد النفسي والسياسي أكثر من ارتباطها بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، فإن البعد السياسي حاضر أيضاً في رغبة بعض الدول في محاربة أعدائها بهذه الطريقة، أي تسخير بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الترويج لتيار معين أو أفكار محددة، وربما مسمومة، مثل تشويه صورة الآخر والدعوة إلى عزله وتهميشه وازدرائه فتقع تلك الصفحات في خطاب الكراهية إما بوعي أو بدون وعي، وخاصة أن المستهدف هو الشباب.
تأثير الانترنيت على تنامي خطاب الكراهية
عادة هناك حاجز وفاصل بين العالم الرقمي أو الافتراضي، والعالم الواقعي أو الميداني، لأن الانترنيت يساعد على إخفاء الهوية ونقل الخطاب بأشكال مختلفة مع قدرة عالية على التأثير في شريحة واسعة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في الواقع الميداني، يصعب الجهر بخطاب الكراهية في المجتمع، لأنه كل مجتمع يحاول الحفاظ على قيم تماسكه وعلى رأسها التسامح وقبول الاختلاف والتضامن والتعاون والرحمة والبر والإحسان.. فلا يجد خطاب الكراهية موقعاً له داخل هذا المجتمع الذي حقق نسبة من النجاح في توفير بيئة آمنة تتعايش فيها كل الطوائف والمذاهب والتيارات، ولذلك فإن الخطابات المتطرفة لا تجد لها مكاناً إلا في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خاصية الاختباء وراء أسماء وهمية.
تعدالقوة الزجرية مهمة في الحد من تزايد خطاب الكراهية في منصات التواصل الاجتماعي، وقد أثبتت فعاليتها في كثير من الأحداث، لكن بالتأكيد لا بد من دعم هذه المقاربة الأمنية، بمقاربة أخرى تربوية وتوجيهية، من خلال إدماج أخلاقيات الانترنيت في البرامج الدراسية وتأهيل الناشئة لكيفية التعامل السليم مع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ سن مبكرة، لأن الجيل الحالي له اهتمامات كبيرة بالانترنيت، وينبغي مدّه بأدوات التحصين حتى لا تجرفه التيارات الدخيلة والتي تستهدف تغيير قيمه وتسخيره لخدمة أغراضها، فالمجتمعات المستقرة والآمنة مستهدفة في تنميتها واستقرارها، ولذلك ينبغي محاصرة كل الخطابات المتطرفة والدخيلة على المجتمعات العربية خاصة، وعلى رأسها خطاب الكراهية.
دور البيئة الاجتماعية في الوقاية أو التعزيز:
تعد الأسرة النواة الأولى لتربية الشباب على التسامح وقبول الاختلاف وفي حالة فشل الأسرة في ذلك فإنها قد تكون مصدراً للقمع أو الإهمال، مما يدفع الشاب للبحث عن “عائلة بديلة” في الجماعات المتطرفة، وهي قضية الهوية البديلة والرغبة في الانتماء إلى مجتمع آخر جديد، والواقع الافتراض اليوم مع تنامي استخدام الانترنيت ووصول هذه الشبكة إلى المناطق النائية، قد جعل التطرف يلج المناطق الهامشية والبعيدة.
بعد الأسرة، تأتي المدرسة لتؤسس الفكر النقدي وتبني الشخصية السوية، وفي حالة عدم نجاحها فإن الشباب يكونون عرضة للاستقطاب والتجنيد في صفوف جماعات متطرفة.
ولذلك ينبغي أن تعمل المدرسة والجامعة على تعزيز قيم التسامح وتقديم أنشطة موازية تخلق مجتمعا متكاملا ومتضامنا ومتقبلا للجميع، سواء أنشطة ثقافية أو فنية أو رياضية تخدم تكوين الشباب، وتأهيلهم لخدمة المجتمع وحمايته.
وتعمل باقي المؤسسات الاجتماعية، والرسمية، على محاصرة خطاب التطرف، باقتراح بدائل تؤسس للتواصل والتسلح بالمعرفة والمهارات الحياتية، وعلى رأسها الاعتزاز بالقيم الدينية والوطنية وفق الخصوصيات المحلية القائمة على الوسطية والاعتدال والتواصل والانفتاح والتسامح والتضامن، لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
أخيراً، إن التطرف ليس قراراً فردياً فحسب، بل نتيجة تفاعل معقد بين جوانب نفسية وعوامل اجتماعية، تتطلب مقاربة شمولية لمحاربة الظاهرة في المهد قبل استفحالها، وتجاوز المقاربة الأمنية إلى حلول بعيدة المدى تكون وقائية من خلال تعزيز الانتماء للوطن والاهتمام بأنشطة الشباب، والمدخل في كل ذلك يكمن في التربية والتمكين للبحث العلمي.