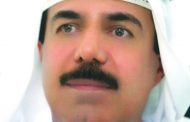بقلم: حسين عبد البصير
عرفت مصر الفرعونية العقوبة!
ووردت إشارات عدة عن السجون في العديد من النصوص المصرية القديمة. ولعل أشهر ما ورد عن وجود السجون بالفعل في مصر القديمة ما جاء في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في الكتب السماوية المقدسة، أي أن مصر القديمة قد عرفت السجون دون شك. وقد مكث سيدنا يوسف عليه السلام بضع سنين داخل السجن. وعندما ظهرت براءته خرج من السجن مكرمًا وفي عظمة تليق به عليه السلام. وهنا يتجلى بوضوح دور العدالة في إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين.
وتؤكد الحقيقة التاريخية والشواهد الأثرية أن مصر القديمة عرفت السجون مُنذ القدم. وقد كانت السجون مكانًا من أجل إعادة التأهيل ولإخراج المُذنب بعد فترة إلى المجتمع وهو صالح تمامًا ويستطيع أن يحيا حياة إنسانية كريمة مرة أخرى في ظل المجتمع المصري القديم الذي كان يقدس قيمة ومفهوم “الماعت” أو العدالة.
وعلى الرغم من أن معلوماتنا عن السجون في مصر الفرعونية قليلة، فيمكن القول إنه بناء على ما تقدم من معرفة مصر الفرعونية بمبادئ تحقيق العدالة، والحق فى الأمن والأمان، وإرساء مبادئ القضاء والعقوبات وإقرار القوانين وتنفيذ الأحكام، وكما سبقت الإشارة، فكان لابد من وجود مكان يوضع به المُذنب من أجل فصله عن المجتمع لفترة ما حتى يعود إلى رشده ويخرج بعد ذلك شخصًا صالحًا للعيش في المجتمع. وكان فى تقييد حرية المذنب مجالاً لتهذيبه وإعادته إلى الصواب.
وعلى هذا الأساس، عرفت مصر الفرعونية عالم السجون. وكان السجن مهمًا داخل المجتمع الفرعوني. ووردت كلمة سجن في اللغة المصرية القديمة تحت اسم “إيتح” و”خنرت”. وكلاهما ظهرا في سياق الحديث عن القلعة أو السجن. وكلمة “خنري” بمعنى “سجين”. وحمل السجن الكبير في طيبة اسم “خنرت ور”. وجاءت كلمة “خنرت” من الفعل ” خنر” بمعنى “قيّد” أو “حبس “.
وفي “قصة خوفو والسحرة” الشهيرة، استفسر الملك خوفو، صاحب الهرم الأكبر بالجيزة من عصر الأسرة الرابعة، من الساحر جدي عن قدرته على إعادة رأس الإنسان المقطوع بسحره مرة أخرى إلى مكانها، فرد عليه الساحر، قائلاً: “نعم”. فأمر خوفو بإحضار أحد السجناء حتى يستخدمه جدي. لكن الساحر رد قائلا: “ليس على رجل يا مولاي”. فأحضروا للساحر إوزة، فقام بإلقاء تعاويذه السحرية، حتى فوجئ الكل برأس الإوزة ينفصل عن الجسم ويطير نحو سقف قاعة العرش، والكل ينظرون إليه بذهول عجيب غير مصدقين أن هذا يمكن أن يحدث أمام أعينهم. وبعد أن طار الرأس إلى أعلى، وجد المشاهدون الرأس يعود مرة ثانية ويلتصق بجسم الإوزة، ثم تجري خارجة إلى حظيرتها. ويمكن أن نستنتج من هذه القصة أن مصر قد عرفت السجون منذ عصر الدولة القديمة وفقًا لسرد الأحداث بهذه القصة. وفي تعاليم “مري كا رع”، جاءت هذه القيمة المهمة حيث يقول: “لا تقتل؛ فان ذلك لا يعود عليك بالفائدة، بل تُعاقب بالضرب والحبس”.
وجاء عدد من الإشارات عن السجون في مصر الفرعونية من عصر الدولة الوسطى حين ذُكر أن الفراعنة كانوا يسجنون الخارجين عن القانون من غير المصريين. وكان سجن اللاهون في إقليم الفيوم واحدًا من أشهر سجون مصر الفرعونية. وعُثر به على قوائم بأسماء بعض السجناء.
وفي عهد الملك رمسيس الثالث تم اتهام بعض السيدات بالسرقة، وأدخلن السجن في مدينة طيبة. ولعل ما بين ما شاع في العصر المتأخر، وكان تقليدًا مختلفًا تمامًا، كان يتم اللجوء إلى العدالة الإلهية فى المعبد الكبير فقط، واُطلق عليه “باب العدالة”، وتصفه النصوص “أنه المكان الذي يُصغى إلى همسات المظلومين حيث يُحاكم الضعفاء والأقوياء على قدم المساواة، وإقامة العدالة ورفع الظلم”.
ويمكن أن استنتاج أن بعض المعابد المُناط بها العدالة والقضاء ضمت سجونًا من أجل حفظ المتهمين فيها، منفصلة تمامًا عن السجون المدنية. ومما يشير إلى ذلك بردية تورين حيث نجد بها جملة “المساجين فى المدينة بالمعبد”، وتُترجم أيضًا بـ “المساجين في المدينة والمعبد”. وبالرغم من أنه لا يوجد شيء صريح يُشير إلى وجود السجون فى معابد مدينة منف، فربما كان وجود تلك السجون شيئًا منطقيًا في ظل الدور الذي لعبه كهنة تلك المعابد باعتبارهم “قضاة العدالة”، وخاصة أنه توجد بعض الإشارات التي يُمكن أن يُستدل منها على وجود سجون مُلحقة بالمعابد الكبرى، وبطبيعة الحال كانت معابد منف، وخاصة العظمى منها.
ومن هنا، نخرج بالقيمة الإنسانية العظمى التي أبدعتها مصر الفرعونية لإصلاح الفرد من خلال الاحتجاز في السجون عبر إرساء مبادئ العدالة وتطبيق القانون.